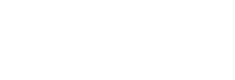قضية فلسطين بالنسبة إلينا قضية أساسية ولن تخرج من لائحة قضايا نظام الجمهورية الإسلامية
قضية فلسطين لن تخرج من لائحة قضايا نظام الجمهورية الإسلامية. قضية فلسطين هي ساحة جهاد إسلامي واجب وضروري، وما من حدث يمكنه فصلنا عن القضية الفلسطينية. قد يكون البعض ممن يتواجد في الساحة الفلسطينية لا يعمل بواجباته، وهؤلاء لهم حساب آخر، إلا أن شعب فلسطين والمجاهدين الفلسطينيين هم موضع تأييدنا ودعمنا.